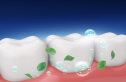البرفسور عبد الله سرور الزعبي
لم تكن أمريكا اللاتينية، يومًا، مجرّد امتدادٍ جغرافي جنوب الولايات المتحدة. فمنذ بدايات القرن التاسع عشر، أدركت واشنطن أن أمنها ونفوذها ومكانتها العالمية تمرّ عبر هذه القارة. فصيغت المبادئ، وتحوّلت الشعارات إلى أدوات دائمة للتدخّل السياسي والعسكري والاقتصادي. من مبدأ مونرو، وصولاً إلى استراتيجية الرئيس ترامب الحديثة، ظلّ السؤال نفسه حاضراً، هل تمثّل أمريكا اللاتينية شريكًا مستقلًا أم انها الحديقة الخلفية تُدار من الشمال؟
عام 1823، أعلن الرئيس مونرو مبدأً، أصبح علامة فارقة في علاقات واشنطن بالقارة اللاتينية. جوهره بسيط في الظاهر، لا مكان لأوروبا، وأيّ تدخل اوروبي سيُعدّ تهديدًا مباشرًا لأمن الولايات المتحدة.
ظاهريًا، جاء المبدأ لحماية الدول اللاتينية من محاولات الاستعمار الأوروبي، لكنه حمل بين سطوره فكرةً واضحة، واشنطن هي الوصيّ على القارة. لاحقاً، تحوّل المبدأ إلى قاعدة استراتيجية تمنع نفوذ الآخرين وتمنح الولايات المتحدة اليد العليا سياسيًا واقتصاديًا، تحت عنوان الحماية، حتى وإنْ كانت مكلفة للآخرين.
مع الوقت، ترسخت العبارة الشهيرة، أمريكا اللاتينية هي الحديقة الخلفية للولايات المتحدة، ليس بوصفٍ جغرافي فحسب، بل باعتبارها فضاءً مغلقًا أمام القوى المنافسة. وبُني على هذه الرؤية دعم أنظمة موالية، والتدخل ضد المتمرّدة، وتشكيل منظومات اقتصادية تمنح واشنطن القدرة على توجيه القرار.
عام 1904 قدّم الرئيس روزفلت، ملحق لمبدأ مونرو. لم يعد الأمر يقتصر على رفض التدخل الأوروبي، بل منح واشنطن حقّ التدخل الاستباقي داخل دول القارة إذا رأت أن الفوضى قد تفتح الباب للأوروبيين. وهكذا تحوّل شعار حماية الاستقلال اللاتيني إلى فرض الوصاية الأمريكية.
عبر العقود، تغيّر الخطاب، الا ان الفكرة بقيت حاضرة، منطقة يجب أن تظلّ تحت السيطرة، حتى لو تغيّرت الأدوات.
نتيجة ذلك، كانت هناك تدخلات عسكرية في كوبا، بعد الحرب الإسبانية-الأمريكية، 1898، أصبحت كوبا عمليًا تحت وصاية واشنطن. ثم ثم أصبحت ساحة مواجهة خلال الأزمة مع الاتحاد السوفيتي، ومحاولة إنزال خليج الخنازير. فرضت واشنطن حصارًا اقتصاديًا طويلًا لا يزال أثره قائمًا. المثال الكوبي تحول من شعار الحماية إلى نزاع ممتد لعقود.
في بنما، دعمت واشنطن الانفصال عن كولومبيا عام 1903، وبنت وسيطرت على قناة بنما حتى 1999، ثم أطاحت بنورييغا عام 1989 تحت شعار استعادة النظام. الهدف ابقاء السيطرة لضمان امتياز النفوذ الأمريكي الاستراتيجي.
في المكسيك، فُضِّل أسلوب التفاوض بدل الاكراه. من نافتا 1994، إلى اتفاق ترامب، تغيّرت القواعد ولكن بقي الهدف، تجارة حرّة، لكن بشروطٍ الأفضلية لأمريكا.
في تشيلي، أسقط انقلابٌ عسكري حكومة سلفادور، بدعم أمريكي، خوفًا من تمدد اليسار. تشيلي أصبحت فيما بعد نموذجًا لتجربة اقتصادية ليبرالية صارمة، لكنها دفعت ثمنًا سياسيًا واجتماعيًا كبيرًا.
وفي فنزويلا، انتقلت واشنطن من الضغوط السياسية إلى العقوبات الواسعة على قطاع النفط، فاستخدم نموذج الخنق الاقتصادي. وانتهى الامر في اعتقال الرئيس مادورو من بيته الرئاسي يوم 4/1/2026. فنزويلا، ينتظرها مستقبل صعب، فسيطرة الشركات الامريكية على النفط والموارد الأخرى لا يمكن ان تتم الا إذا تعاونت الحكومة الفنزويلية، او ستعم الفوضى فيها، وتخسر فنزويلا أكثر من النفط. على الرغم من ان البنية التحية للصناعة النفطية متهالكة، الا انه استثماره، سيكون له انعكاس كبير ليس على فنزويلا او أمريكا، بل على أسواق النفط العالمية، وقد ينهي منظمة أوبك، وينعكس سلباً أثره على الصين وأوروبا، ودول مجاورة أخرى وغيرها.
وتكرّر المشهد في غواتيمالا (1954)، ونيكاراغوا في الثمانينيات، وغرينادا (1983)، وجمهورية الدومينيكان (1965)، إضافة إلى تدخلات مباشرة وغير مباشرة في دول أخرى، بدوافع تتراوح بين مكافحة المخدرات، والفساد، وضمان الاستقرار، وترتيبات اقتصادية، تكرس صورة أمريكا كمسيطر على القارة.
هكذا أضيفت طبقة جديدة فوق مبدأ مونرو، التدخل الوقائي باسم النظام.
خلال الحرب الباردة، أصبحت القارة ساحة صراع بين واشنطن وموسكو. وبعد سقوط الاتحاد السوفييتي تغيّر الخطاب إلى الخصخصة، والإصلاحات الاقتصادية، ومكافحة الفساد، ومحارة المخدرات، لكن الجوهر بقي ثابتًا، بقاء القارة داخل المدار الأمريكي.
الرئيس ترامب، لم يُلغِ الإرث القديم، بل صاغه بأسلوب أكثر مباشرة يخدم شعار أمريكا أولًا. ركّز على الأمن والهجرة والحدود. معتبرها قضايا أمن قومي. في الاقتصاد، أعاد التفاوض على الاتفاقيات، وفضّل الصفقات القصيرة الواضحة على الوعود الطويلة. لكن الرئيس ترامب، يرى ابعد من ذلك.
لكن المعركة لم تعد داخل القارة فحسب، فالحاجة دفعت دول أمريكا اللاتينية للحصول على التمويل لإنشاء البنى التحتية والاستثمار من قوى اخرى، وعلى رأسها الصين، التي توسعت عبر الاستثمارات والديون. فارتفعت تجارتها مع دول القارة إلى نحو 450–480 مليار دولار بعد أن كانت أقل من 20 مليار عام 2000، وانضمت أكثر من 20 دولة لاتينية إلى مبادرة الحزام والطريق. وهكذا تحوّلت المنطقة إلى فضاء تنافسي مفتوح بدل من ساحة أمريكية خالصة. الصين وغيرها لم تعد ابهة بنظرية الحديقة الخلفية، بل اعتبار المنطقة، متعددة الشراكات، ولبناء توازنات جديدة.
هنا عاد صدى مبدأ مونرو، القارة ليست ممرًا لنفوذ الآخرين، مع الميل إلى الضغط الاقتصادي والعقوبات والتحالفات الموضعيّة بدل الاحتلالات المكلفة.
أمام هذا الواقع، تواجه دول أمريكا اللاتينية خياراً تاريخياً، إما قبول الاصطفاف وفق شروط واشنطن، أو محاولة بناء استقلالٍ متوازن عبر تنويع الشركاء، مع بناء مؤسسات قوية داخليًا، تحمي القرار من الفساد وهشاشة الأحزاب وتذبذب السياسات. كما أن الاندماج الإقليمي للدول اللاتينية، لم يرتقِ لمستوى الاتحاد الأوروبي، ليشكل شرطًا للتفاوض بندّية مع القوى الكبرى. الفشل اللاتيني، يعني تكرار الدورات القديمة من الديون والانقلابات الناعمة والتبعية، ولكن بثوبٍ جديد.
رسالة واشنطن واضحة، الجزء الغربي من الكرة الارضية خط أحمر. لكن ما الذي تعنيه السياسة الامريكية لبقية العالم؟ هل هو تقاسم أدوار، أم تصادم نفوذ؟
المشهد لا يخصّ القارة وحدها. فكما تحمي روسيا جوارها القريب، والصين بحارها الشرقية، تصرّ واشنطن على محيطها الاستراتيجي. العالم يعود إلى منطق تقاسم النفوذ بدل العولمة المفتوحة. وكلما اشتدّ الصراع على أمريكا اللاتينية، زادت الانقسامات الدولية، وتقدّمت المصالح على المبادئ.
النتيجة ليست تقاسمًا هادئً للأدوار، بل سلسلة تفاوض وصراع، من حيث النفوذ الاقتصادي مقابل نفوذ أمني، وقروض واستثمارات مقابل تحالفات سياسية، وتداخل أعمق بين المحلي والعالمي. وهذا ما يجعل الدول الصغيرة والمتوسطة أمام خيارات صعبة، لكنها أيضًا تمتلك هامشاً للمناورة إذا أحسنت توزيع شراكاتها.
من جيمس مونرو إلى دونالد ترامب، لم يتغير السؤال المركزي، من يملك حق تقرير مصير أمريكا اللاتينية؟ المبادئ قُدِّمت بلباس الحماية، لكن الواقع ترجم إلى صراع نفوذ طويل. واليوم، مع تمدد الصين وروسيا عبر التجارة والبنى التحتية والديون، تتشكل خريطة جديدة للنفوذ. فهل تحول القارة هذا التزاحم إلى فرصة للاستقلال والتنمية، او انها تستسلم لتاريخٍ يعيد نفسه؟ وهل ستبقى ميدانًا تتقاطع فيه الاستراتيجيات، من مونرو إلى ترامب، وما بعدهما؟
مواقف الدول اللاتينية والعالمية الكبرى ستجيب على ذلك خلال السنوات القلية المقبلة.
رغم كل المنافسة الدولية، لا تزال أمريكا، تمتلك نفوذًا عميقًا تاريخيًا واقتصاديًا وأمنيًا، إذ تتجاوز تجارتها مع القارة تريليون دولار سنويًا. والسؤال المفتوح، هل ستسمح واشنطن بتحوّلٍ يُضعف تفوقها هناك؟ الجواب ببساطة. فالاستراتيجية الامريكية لم تتغير اتجاه القارة عبر العقود.
وهنا يبرز موقع الشرق الأوسط. فكما ترى واشنطن أمريكا اللاتينية مجالًا خاصًا، وتشدد قبضتها هناك، تسعى القوى الكبرى لبناء نفوذ عميق في قلب العالم. الصين وروسيا والهند والاتحاد الأوروبي، سندفع بشكل أكبر للبحث عن بدائل للطاقة والغذاء والموانئ، والشرق الأوسط أحد أهمها. هذا يفرض على الدول العربية فهم الخطوط الحمراء لكل قوة، وإدارة التحالفات بذكاء، لا بالارتهان. وهذه فرصة لتعزيز الموانئ، واللوجستيات، والأمن الغذائي، والطاقة التقليدية والمتجددة.
لكن التجربة اللاتينية تحذرنا، التبعية المالية تتحول سريعًا إلى تبعية سياسية. لذا يصبح تنويع الشركاء، وربط الاستثمار بإصلاح مؤسسي حقيقي، لا بالمشروعات الرمزية، وبناء اقتصاد إنتاجي، شرطًا للحفاظ على الحد الأدنى للقرار الوطني. كما يمكن للدول العربية، إن أحسنت الحساب، تحويل التنافس الدولي إلى رافعة للتنمية بدل أن تكون ساحة للصراع.
اليوم يقف العالم بين خيارين، فرصة القرن أو إعادة إنتاج الماضي. فالصين قادمة بقوة، وأوروبا تعود بخجل، وروسيا تبحث عن موطئ قدم. الا ان الثابت اليوم، من مونرو إلى روزفلت، ومن الحرب الباردة إلى ترامب، ظلّ المضمون واحدًا، من يملك حق تحديد مستقبل أمريكا اللاتينية والنفوذ في الشرق الاوسط. فمصطلح الحديقة الخلفية لأمريكا اللاتينية وتقاسم الشرق الاوسط، لن يبقى قائمًا إلا بقدر ما تقبل به الشعوب.
ان اعتقال الرئيس الفنزويلي، كحدث تاريخي، سيؤدي الى تصاعد الدعوات الإقليمية للسيادة والديمقراطية والعدالة الاجتماعية، مع محاولات لتحويل الإرث المؤلم من التدخلات إلى فرص للإصلاح وبناء مؤسسات أقوى. فأمريكا اللاتينية اليوم أمام خيار تاريخي، فإما أن تحوّل تعدد القوى إلى فرصة لتوازن الاستقلال والتنمية، أو تقبل بالتبعية بثوب جديد.
العالم يتجه الى خرائط نفوذ مرنة، وتحالفات براغماتية، ومناطق محمية تتشكل بسرعه. دول الشرق الأوسط، عليها قراءة المشهد بعمق، وتتصرف بدقة وحكمة لكن بسرعة، وبخلاف ذلك عليها ايضاً ان تقبل بالتبعية، وتخرج بأقل الاضرار قبل ان تتحول المنطقة الى ساحة مفتوحة للصراع، لا يعلم احد اين سينتهي.
من يُحسن إدارة هذا المشهد سيكسب، ليس بالشعارات، بل ببناء مؤسسات قوية، وعقد اجتماعي متين، وتنوّع الشركاء، وربط السياسة بالاقتصاد المنتج.