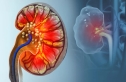نبض البلد - حسام الحوراني
في عالم يتجه بخطى متسارعة نحو الرقمنة، يطلّ الذكاء الاصطناعي كقوة خارقة قادرة على إحداث تغييرات جذرية في شتى مناحي الحياة. فمن تشخيص الأمراض إلى تسهيل الوصول إلى المعرفة، ومن تحسين التعليم إلى تعزيز الكفاءة في أنظمة العدالة، يبدو الذكاء الاصطناعي كأداة للتحرير الإنساني. لكن، وفي الزاوية المقابلة، يطرح صعود هذه التكنولوجيا تساؤلات جوهرية تهزّ أركان القيم الحقوقية: هل يحمي الذكاء الاصطناعي حقوق الإنسان أم يُهددها؟
الذكاء الاصطناعي، كأي أداة، ليس خيرًا ولا شرًا بطبيعته، بل تعتمد نتائجه على كيفية تصميمه واستخدامه. من جهة، يمكن أن يكون هذا الذكاء حليفًا قويًا في حماية الحقوق، ومن جهة أخرى، قد يتحول إلى أداة مراقبة وسيطرة وتمييز غير مرئي، إذا لم يُحكم ضبطه بإطار أخلاقي وقانوني صارم.
لنبدأ من الجانب المضيء. الذكاء الاصطناعي يُستخدم اليوم في تعزيز الوصول إلى العدالة، عبر تحليل ملايين الوثائق القانونية بسرعة فائقة، ومساعدة المحامين في بناء قضايا عادلة، بل وحتى دعم القضاة في إصدار أحكام أكثر اتساقًا. كما تُستخدم تقنيات التعلم الآلي في رصد خطاب الكراهية، والتنمر، والتحريض على العنف عبر الإنترنت، مما يتيح التدخل المبكر وحماية الأفراد، خاصة الفئات المستضعفة كالأطفال والنساء والأقليات.
في مجال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وفّر الذكاء الاصطناعي أدوات مبتكرة تُعزز من الاستقلالية والدمج المجتمعي. تطبيقات التعرّف على الصوت، والنصوص التلقائية، والرؤية الحاسوبية، جعلت العالم أكثر قابلية للوصول لذوي الاحتياجات الخاصة، في خطوة عملاقة نحو المساواة والعدالة.
لكن في المقابل، لا يمكن إنكار الجانب المظلم. فالذكاء الاصطناعي، بقدر ما يُمكّن، يمكنه أن ينتهك الخصوصية، ويُرسّخ التمييز، ويُقوّض الحريات. أبرز مثال على ذلك هو أنظمة التعرف على الوجه، التي تُستخدم في بعض الدول لمراقبة المواطنين في الأماكن العامة، دون علمهم أو موافقتهم، في مشهد أشبه بروايات الديستوبيا التي طالما حذّر منها الأدب السياسي.
هذه الأنظمة قد تُستخدم لأغراض مشروعة، مثل تعزيز الأمن، لكنها في غياب الرقابة، قد تُصبح أداة للرقابة السياسية، أو لاستهداف فئات بعينها، أو للتضييق على الحريات العامة، مثل التظاهر والتعبير والتنقل. وبهذا، يتحول الذكاء الاصطناعي إلى عين رقمية تراقب الجميع... ولا تُراقب من أحد.
أكثر ما يُقلق في هذا السياق هو ما يُعرف بـ"التحيز الخوارزمي"، حيث يتعلم الذكاء الاصطناعي من بيانات بشرية قد تكون مليئة بالتمييز العنصري، أو الجندري، أو الطبقي. فإذا كانت البيانات المستخدمة في تدريب الخوارزميات غير منصفة، فإن القرارات التي تُنتجها — سواء في التوظيف، أو القروض، أو الحكم القضائي — ستكون منحازة، وقد تُعمّق الظلم بدلًا من معالجته.
وفي هذا المشهد المعقد، تظهر الحاجة المُلحّة إلى إطار حقوقي عالمي يُنظّم العلاقة بين الذكاء الاصطناعي وحقوق الإنسان. فكما وُضعت اتفاقيات لحماية حقوق الإنسان في أوقات الحرب والسلام، بات من الضروري اليوم وضع "اتفاقية رقمية لحقوق الإنسان"، تُحدد ما يمكن وما لا يمكن للخوارزميات فعله، وتُرسي مبادئ الشفافية، والمساءلة، والعدالة، والخصوصية، في كل ما يتعلق بالذكاء الاصطناعي.
كما أن مسؤولية حماية حقوق الإنسان في عصر الذكاء الاصطناعي لا تقع على عاتق الحكومات فقط، بل تشمل الشركات التقنية، والمطوّرين، والمجتمع المدني، والأكاديميين. يجب أن يكون هناك وعي جماعي بأن الخوارزميات ليست محايدة، وأنها قد تُعيد إنتاج الواقع بقسوته، إذا لم نتدخل لتوجيهها نحو العدالة والمساواة.
وفي العالم العربي، تُمثّل هذه المرحلة فرصة نادرة لتبنّي الذكاء الاصطناعي ضمن رؤية تنموية وحقوقية شاملة، تحفظ الكرامة الإنسانية وتعززها، لا أن تُحوّل المواطن إلى "بيانات قابلة للتتبع" فقط. يجب أن تُوضع استراتيجيات رقمية وطنية تدمج مبادئ حقوق الإنسان في تصميم وتطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي، مع سنّ تشريعات واضحة، وتطوير مؤسسات رقابية مستقلة.
اخيرا، الذكاء الاصطناعي لن يقرر مستقبلنا وحده، بل نحن من سنقرر شكل الذكاء الذي نريده. يمكننا أن نصنع ذكاءً يدافع عن الحقوق، يُنصف الضعفاء، ويُعزز من العدالة. كما يمكننا، إن تجاهلنا مسؤوليّتنا، أن نُطلق العنان لتقنيات قد تنسف ما حققناه من مكتسبات إنسانية عبر عقود من النضال.إن التحدي الأخلاقي اليوم لا يقل أهمية عن التحدي التكنولوجي. والسؤال الأكبر ليس: إلى أين يمكن أن يأخذنا الذكاء الاصطناعي؟ بل: إلى أي مستقبل نريد أن نأخذه نحن؟