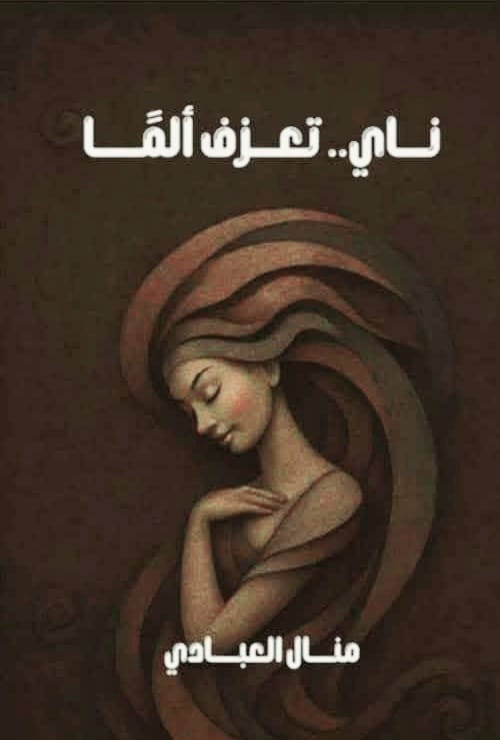نبض البلد -
قراءة: أُسَيْد الحوتري
يُنظر إلى القلم النسوي في الكتابة الأدبية على أنه صوت مغاير للقلم الذكوري، لا يختلف عنه من حيث اللغة والأسلوب فحسب، بل من حيث زاوية الرؤية وتوجه الاهتمام. فالكتابة الذكورية غالبًا ما تنشغل بالهمّ الجمعي من منظور خارجي يركّز على البطولة، والصراع، والإنجاز الفردي في فضاء اجتماعي أو سياسي، بينما تبدأ الكتابة النسوية من الداخل، من تفاصيل الجسد والروح والذاكرة، حيث تسكن الجراح اليومية والمعاناة الصامتة. ومن هنا، فهي لا تسعى إلى تزيين التجربة الأنثوية أو تلطيفها، بل إلى كشف ما هو مقموع في الوعي الجمعي، وإضاءة بنية القهر الاجتماعي والرمزي التي تقيّد المرأة. لقد أكّد النقد النسوي أن النصوص التي تُكتب من منظور أنثوي تكشف عن تجارب مغايرة في بنيتها وسردها، إذ تحمل حساسية خاصة تجاه الجسد، وتحوّل الألم والوجع إلى خطاب مقاوم، في مقابل الكتابة الذكورية التي كثيرًا ما تقدم المرأة في قوالب نمطية تقليدية، وتسقط عليها تصورات جاهزة عن الجمال والدور الاجتماعي.
في رواية «ناي تعزف ألماً» للكاتبة منال العبادي، تتجلى ملامح الكتابة النسوية بوضوح، حيث تصبح الكتابة نفسها فعل مقاومة ضد التهميش، وصوتًا يُعيد للمرأة حقها في أن تُرى وتُسمع. وستعرض هذه المقالة مجموعة من هذه الملامح النسوية:
أولا، طبيعة حضور الشخصيات وبنية السرد. إذ تنبني الحكاية على بطلات نساء في المقام الأول، وعلى رأسهن سارة التي تتحول إلى المركز السردي، فتتحدّد الأحداث والانعطافات الدرامية من خلال تجربتها الذاتية. كما تبرز شخصية نور لتؤكد هذا الاختيار السردي الذي يعلي من الصوت النسائي، ويجعل من المرأة الفاعل الأساس لا التابع أو الهامش. وهذا التمركز حول "البطلة" أو الشخصية الرئيسية يكشف عن خصوصية الكتابة النسوية التي لا تكتفي بجعل الأنثى موضوعاً فقط أو موضوعاً غرامياً، بل تجعلها الموضوع/الذات، أي الوعي المنتج للسرد والحامل له. إن حضور المرأة هنا ليس من باب لزوم ما لا يلزم أو الزينة أو مجرد خلفية للأحداث، بل هو الأساسات التي تقوم عليها والبنية التي تتشكل منها القصة كلها، وهو ما يضع النص في قلب المشروع الأدبي النسوي الذي يصرّ على إعادة المرأة إلى مركز الكتابة، بعد أن ظلت طويلاً على هامش النصوص التي خطّها الأدب الذكوري.
ثانيا، معاناة المرأة، لقد ركزت الكاتبة في رواية "ناي تعزف ألماً" على آلام المرأة عموما، وآلام سارة على وجه الخصوص، التي تتحول إلى مرآة عاكسة لوجع الأنثى في مواجهة الفقد والحب والقيود الاجتماعية. إن قصتها تتجاوز حكاية حب ينكسر عند عتبة الموت، فتتعدّاها إلى حكاية جسد وروح يتنازعان بين الحياة كما يريدها القلب والحياة كما يفرضها المجتمع. حين فقدت سارة حبيبها أحمد، لم يكن موته موتاً عادياً في سرد تقليدي، بل كان انطفاءً لأنوثة كاملة، وانهياراً لذاتٍ لم تعرف للحظة أن تعيش خارج ظل المحبوب. تقول: «أيامي لن تعود... لقد غابت بغيابك...»(ص. 53)، وهنا يصبح الغياب استعارة لمحو المرأة من خريطة الوجود، كأن الحب هو ما يبرر حضورها في العالم.
لا يتوقف الفقد عند الموت، بل يتضاعف في تفاصيل الأشياء اليومية التي تتحول إلى أشباح تلاحقها. القميص الأزرق الذي كان رمزاً للفرح يصبح كفناً يلتف حول عنقها، فتقول: «القماش الناعم، الذي كان يومًا ناقلًا للفرح، أصبح الآن كفنًا لذكرى، علقت أنفاسها في حلقها كشظية زجاج.» (47). هنا يفضح النص كيف يُحوِّل الحنين جسد الأنثى إلى ساحة عذاب، وكيف يصبح الحب بعد الفقد أداة قمع لا تقل عن سلطة المجتمع.
إلى جانب الألم العاطفي، نجد قمع العائلة والتقاليد يضاعف مأساة سارة (الشخصية الرئيسية في رواية مراد). فهي لم تكن فقط الحبيبة التي خسرت رجلاً، بل أيضاً المرأة الفقيرة التي لم يُسمح لها بالحب أصلاً، إذ تقول: «أرملة، أم لطفلين...، تعيش على القليل، لا أهل يساعدون، ولا اعتراف بها أو بأولادها من عائلته...» (140). في هذا المقطع، تتحول الأنثى إلى عبء اجتماعي، وتُختزل كينونتها في صورة الخطيئة التي تلاحقها، ما يكشف عن البنية الأبوية التي تحاصرها وتمنعها من تقرير مصيرها العاطفي.
ولأن المجتمع ضيّق عليها الخناق، كان من الطبيعي أن تصل إلى الانهيار النفسي، محاصرة بذكريات الحبيب وبأصوات الداخل والخارج. نراها في المستشفى تحاول الكتابة على الجدران لتحرير نفسها، لكنها تُربط كالمذنبة، وتقول: «كنت أحرر نفسي... والآن يشاغبني طيفك وأنا كفراشة ترقص وهاهي تعانق السماء.» (161). هنا تُستعاد صورة الجسد الأنثوي المقيد، الذي لا يُسمح له حتى بأن يصرخ أو يكتب أو يبوح، وكأن سلطة الذكورة تتجسد في رباط المستشفى الذي يقيد يديها.
بهذا المعنى، تصبح معاناة سارة شهادة نسوية على أن الحب في مجتمع أبوي ليس مجرد تجربة عاطفية، بل صراع مزدوج مع الفقد ومع القيود التي تحرم الأنثى من حقها في الحزن، في الحب، وفي تقرير مصيرها. فالموت لم يسرق منها الحبيب فحسب، بل سرق منها حقها في الوجود ذاته، وجعلها أسيرة لذاكرة لا ترحم ومجتمع لا يغفر.
ثالثا، معالجة قضايا نسوية خاصة: تقدم الرواية شخصية نور بوصفها مرآة لمعاناة الجسد المختلف، جسد الأنثى الذي أرهقه خلل هرموني فجعله قريبًا من صفات الذكور. وهذه مشكلة خاصة بالنساء، فمن يزداد لديها الهرمونات الذكورية يتحول جسدها إلى عبء نفسي واجتماعي يلاحقها كما حدث منذ الطفولة مع نور التي كانت في صراع مع جسدها بسبب «ذلك الوجه المليء بالشعر، ذلك الزغب القاسي الذي يذكرها بوجوه الرجال، وتلك العضلات التي نمت بطريقة تمردت على أنوثتها. حتى ذلك الصوت الذي مهما حاولت أن تلين من خشونته يبقى فاضحا، ملفتا، مثيرا للأسئلة من قبل من حولها.» (109). هنا يتجسد القهر في صورته الأكثر قسوة: جسد لا يعكس حقيقة الذات، ومجتمع لا يرحم الاختلاف، حتى يصل الأمر إلى اتهامها بما لا يتفق مع هويتها: «الوصمة ليست باتهامها بأنها "شاذة" فهي ليست كذلك، هي فتاة بوضوح في قلب من يعرفها، بل لأن جسدها لم يعكس الحقيقة بجلاء.» (108).
تغوص الرواية في الأثر النفسي لهذا الاضطراب، لتكشف عزلة نور وخيباتها المتكررة، لكنها في الوقت نفسه تضيء مقاومتها الداخلية ورفضها الاستسلام. رحلتها مع العلاج الهرموني والجراحة لا تُقدّم كمسار طبي بارد، بل كسردية نسوية عن استعادة الجسد والحق في الأنوثة: «أخذت موعدًا من الطبيب لتبدأ معه العلاج… لم تكن رحلة نور سهلة، العلاج الهرموني كان بطيئًا كقطرات الماء.» (111). ومع هذا البطء والألم، يعلو صوتها أخيرًا ليعلن الانتصار: «أنا هنا، أنا موجودة، وأنا... فتاتكم نور.» (110). إنه إعلان رمزي يختزل فلسفة النص: الوجود اعتراف، والاعتراف مقاومة.
رابعا، الرموز النسوية: لجأت الكاتبة إلى رموز نسوية بارزة لتجسيد هذا الصراع؛ فكانت المرآة الفضاء الذي واجهت فيه نور ذاتها، مرآة تعكس ظاهر نور، صورتها في عيون الناس، ولكنها لا تعكس جوهرها وصورة روحها: «لم تكن بحاجة لترى نفسها في المرآة، شعرت بانحناءات روحها الأنثوية تتنفس بحرية» (110). أما الفستان الوردي الذي احتفظت به رغم اهترائه فقد شكّل رمزًا لأنوثتها المخفية وإصرارها على التشبث بهويتها في مواجهة الإنكار: «أخرجت فستاناً زهرياً بسيطا، ...كان رمزا لأنوثتها التي لا تشك فيها» (109). كذلك، يتحول العلاج الهرموني من مجرّد وسيلة طبية إلى علامة على إصرار المرأة على إعادة امتلاك جسدها وانتزاع حقها في الوجود. وأخيرًا، فإن اسم البطلة «نور» نفسه لم يتم اختياره بالمجان، إذ يحمل دلالته الرمزية على الضوء الذي يتغلب على العتمة، وعلى الإرادة التي لا تنطفئ: «تحمل في داخلها ناراً لا تنطفئ، نار الإرادة.» (111).
خامسا، نقد المنظومة الذكورية: كما تنتقد الرواية المنظومة الذكورية التي تختزل المرأة في مظهرها الخارجي، حيث تصبح معايير الجمال السطحية سجنًا يقيد الهوية ويحدّ من الحرية. يظهر ذلك في همس المجتمع حول شكل نور: «حتى عمتها كانت تهمس لأمها بقلق: انتبهي الناس بتسأل ليش شكلها مش زي البنات… » (107). بهذا تنكشف الصور النمطية التي تجعل من المرأة جسدًا يُفحص، لا كيانًا يُعترف به. بالإضافة إلى صور عديدة لظلم المرأة وقمعها.
خامسا، وآخر الملامح النسوية في الرواية التي سنتطرق لها هي المستوى اللغوي: فتتخذ الكاتبة من البلاغة الشعرية أداةً لإضفاء عمق إنساني على التجربة النسوية، إذ يتحول الألم إلى استعارات والنص إلى نغم وجداني: «سلامٌ ينساب كالندى على قلوبٍ لم تعرف نبض الحب، قلوبٍ ظلت بكرًا كصفحاتٍ بيضاء في كتاب الزمن» (6). بهذه اللغة التي تتجاوز المعتاد إلى اللغة الشعرية والشاعرية، يتحول صوت المرأة إلى خطاب وجداني نابض، يثير التعاطف ويكشف الأبعاد الأعمق للتجربة الإنسانية.
إن رواية «ناي تعزف ألماً» تقدم نصًا نسويًا بامتياز، يفضح البنية الاجتماعية الذكورية، ويعالج قضايا الجسد والهوية والهشاشة الاقتصادية، ويحوّل التجربة الفردية إلى صرخة جماعية عبر بناء السرد على شخصيات أنثوية. كما يمنح النص رموزًا أنثوية قوية لتتحول الرواية إلى خطابٍ متكامل يربط بين الجرح الفردي والمعاناة الجماعية. إنها كتابة تنطلق من الداخل لتعيد للمرأة صوتها المقموع، وتكتب حضورها في مواجهة مجتمع يصرّ على تغييبها. وبذلك تؤكد منال العبادي أن القلم النسوي ليس مجرّد اختلاف في الأسلوب، بل هو فعل مقاومة معرفية وجمالية، يوسّع آفاق الأدب ويجعل منه أداة لفضح القهر وإعادة الاعتبار للوجود الأنثوي.