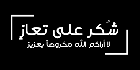نبض البلد -
منصور البواريد
تمثل فئة الشباب في الأردن نسبة كبيرة من عدد السكان، حيث تشير الإحصاءات الرسمية إلى أن ما يزيد عن 60% من المواطنين هم دون سن الثلاثين. وتبرز أهمية هذه الفئة ليسَ فقط من حيث الكمّ السكاني، بل من حيث الدور الكامن الذي يمكن أن تلعبه في تعزيز التنمية الشاملة، إذا ما أُحسن توجيهها واستثمار طاقاتها.
غير أنَّ الواقع الحالي يُشير إلى فجوة واضحة بين الإمكانات الشبابية والفرص الفعلية المتاحة، حيث ترتفع معدلات البطالة بين الشباب بشكل مقلق، وتبرز مشكلات بنيوية في أنظمة التعليم والتدريب والتشغيل، إلى جانب ضعف التمكين السياسي والاجتماعي والثقافي.
تهدف هذهِ الورقة إلى تحليل واقع الشباب الأردني من منظور تنمية المهارات والطاقات، عبر تفكيك المعيقات القائمة، واستعراض التجارب الناجحة، واقتراح سياسات عملية لتحويل هذهِ الفئة من عبء اقتصادي محتمل إلى ركيزة تنموية أساسية.
أولًا: الواقع الشبابي في الأردن، "أرقام وتحديات":
يواجه الشباب الأردني تحديات متشابكة تتعلق بسوق العمل، والتعليم، والمشاركة العامة. وفقًا لبيانات دائرة الإحصاءات العامة، تجاوز معدل البطالة بين الشباب (الفئة العمرية 15-24) نسبة 47% في بعض الأعوام الأخيرة، ما يجعلها من الأعلى إقليميًّا. وتزداد حدة المشكلة بين حملة الشهادات الجامعية، الأمر الذي يعكس اختلالًا واضحًا في العلاقة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل.
وتكشف مؤشرات أخرى عن تراجع في معدلات المشاركة الشبابية في الحياة السياسية والنقابية، وضعف الانخراط في العمل التطوعي والمؤسسي، وهو ما يرتبط جزئيًّا بغياب الثقة في فاعلية المؤسسات الرسمية، إلى جانب ضعف سياسات الاحتواء والتمكين.
على مستوى السياسات، رغم وجود عدد من الاستراتيجيات والمبادرات الحكومية المتعلقة بالشباب، إلا أنَّ كثيرًا منها يفتقر إلى الاستدامة والتمويل الكافي، وتُنتقد لغياب البُعد التشاركي مع الشباب أنفسهم، ما يجعل أثرها الفعلي محدودًا.
ثانيًّا: فجوة المهارات، وضعف التكوين المهني وتحديات المواءمة:
يُظهر تحليل منظومة التعليم في الأردن محدودية في قدرتها على تزويد الشباب بالمهارات اللازمة للانخراط الفعَّال في سوق العمل، سواء من حيث المهارات التقنية أو المهارات الناعمة مثل التفكير النقدي، والعمل الجماعي، وحل المشكلات. كما أنَّ نسبة الملتحقين ببرامج التعليم المهني والتقني لا تزال متدنية، بالرغم من الحاجة المتزايدة إلى هذا النوع من الكفاءات في القطاعات الإنتاجية.
وتُظهر مراجعة السياسات الوطنية ذات الصلة غياب إطار وطني فعَّال لتحديد المهارات المطلوبة على المدى المتوسط والبعيد، إضافة إلى ضعف التنسيق بين وزارات التربية والتعليم، والتعليم العالي، والعمل، والقطاع الخاص، فينعكس ذلك في تكرار تخريج أفواج من الشباب دون وجود مسارات مهنية واضحة، مما يؤدي إلى إهدار الطاقات وزيادة معدلات البطالة.
من جهة أخرى، تفتقر المؤسسات التعليمية، بما فيها الجامعات، إلى شراكات استراتيجية مع القطاعات الاقتصادية المختلفة، ما يحد من فرص التدريب العملي والتأهيل أثناء الدراسة، ويؤدي إلى ضعف جاهزية الخريجين للاندماج في سوق العمل فور التخرج.
ثالثًا: ريادة الأعمال والابتكار، والإمكانيات المعطلة:
رغم المبادرات المتفرقة في مجال دعم ريادة الأعمال، لا تزال البيئة التنظيمية والمؤسسية في الأردن تُشكِّل عائقًا أمام نمو المشاريع الريادية الشبابية، إذ يواجه رواد الأعمال الشباب صعوبات في الحصول على التمويل، وفي التعامل مع الإجراءات البيروقراطية المعقدة لتسجيل المشاريع أو الحصول على التراخيص، فضلًا عن غياب نظام ضريبي مشجع للمشروعات الناشئة.
ورغم وجود عدد من الحاضنات والمسرّعات التي تستهدف الرياديين، إلا أنَّ انتشارها الجغرافي محدود، وتتركز أغلبها في العاصمة، مما يُضعف من العدالة في الوصول إلى الفرص خاصة في المحافظات. كما أنَّ ثقافة ريادة الأعمال لا تزال غير مدمجة بفعالية في مراحل التعليم المختلفة، ولا توجد سياسة وطنية موحدة لتعزيزها ضمن رؤية اقتصادية شاملة.
ويُشير عدد من التقارير إلى أنَّ الاستثمارات الموجهة إلى الشركات الناشئة في الأردن لا تزال متواضعة مقارنة بدول الإقليم، ما يعكس الحاجة إلى بيئة تشريعية ومالية أكثر تحفيزًا، وإلى تحول في النظرة الرسمية للمشاريع الريادية من كونها مبادرات صغيرة إلى كونها محركات للنمو الاقتصادي.
رابعًا: السياسات الشبابية، وتقييم نقدي للأطر القائمة:
منذ بداية الألفية، شهد الأردن إطلاق عدد من السياسات والاستراتيجيات الوطنية الخاصة بالشباب، مثل الاستراتيجية الوطنية للشباب (2005–2009، ثم 2019–2025)، إضافة إلى تأسيس مؤسسات مثل وزارة الشباب ومراكز شبابية منتشرة في المحافظات، غير أنَّ هذهِ السياسات، على الرغم من شموليتها النظرية، تعاني من ضعف التنفيذ وغياب مؤشرات الأداء القابلة للقياس، فضلًا عن ضعف التمويل والتنسيق بين الجهات المعنية.
فقد تلعب وزارة الشباب دورًا محوريًّا في رسم السياسات الشبابية وتطبيق البرامج الوطنية، إلا أنَّ دورها ما زال بحاجة إلى إعادة تموضع وتوسيع ضمن إطار وطني شامل لتأهيل وتمكين الشباب. فيجب أن تتحول الوزارة من جهة تنفيذية تقليدية إلى هيئة تنموية واستراتيجية، تقود التنسيق بين الجهات المختلفة، وتعمل على بناء شراكات مع القطاع الخاص والمجتمع المدني، وتتبنى نماذج مبتكرة في التدريب، والتوظيف، وريادة الأعمال. كما ينبغي إعادة النظر في الهيكل المؤسسي للوزارة وتوسيع صلاحياتها، وتوفير موازنات مرنة تمكنها من تنفيذ خططها بفعالية.
يُلاحظ أنَّ المُقاربة الرسمية في التعامل مع قضايا الشباب تركز غالبًا على الأنشطة الثقافية والرياضية والتوعوية، دون التطرق الجاد إلى القضايا الاقتصادية والبنيوية التي تمسُّ الشباب بشكل مباشر، كالبطالة، وضعف الحماية الاجتماعية، وانعدام التمثيل في مؤسسات صنع القرار.
وتفتقر السياسات الشبابية الحالية إلى آلية واضحة لمشاركة الشباب في صنع السياسات العامة، كما أنَّ المجالس الشبابية المُشكَّلة لا تتمتع بصلاحيات مؤثرة، ما يحدُّ من فاعليتها ويجعلها أقرب إلى الهيئات الرمزية. كما أنَّ برامج التَّمكين تظل محدودة الأثر، نتيجة غياب الرؤية الوطنية طويلة المدى لدمج الشباب في العملية التنموية بشكل حقيقي ومستدام.
خامسًا: الهوية والوعي والشباب كفاعل ثقافي واجتماعي:
لا يُمكن اختزال الشباب في الأردن ضمن أطر اقتصادية ومهنية فقط، فهذهِ الفئة تلعبُ دورًا حاسمًا في تشكيل الثقافة العامة والوعي الاجتماعي. وقد ساهم غياب المساحات الفكرية المستقلة، وضعف الإعلام العام والتربوي الموجه للشباب، في بروز حالة من التفكك القيمي والتناقض بين الانتماء العاطفي للدولة والانفصال عن مؤسساتها.
فإنَّ تعزيز الوعي والانتماء ليسَ شأنًا نخبويًّا، بل يتطلب إعادة ربط الشباب بالواقع السياسي والاجتماعي بشكل نقدي ومسؤول، قائم على القيم الدستورية، والتاريخ الاجتماعي، والتنوع الثقافي الأردني، ويقترن ذلك بإدماج الشباب في برامج ثقافية وفكرية تُحفِّز الحوار، والنقد البناء، وتفتح الآفاق أمام التفكير الحر والمبادرة.
كما أنَّ المساحات الرقمية، رغم ما تتيحه من حرية، باتت تحديًّا مزدوجًا من حيث انتشار خطاب العدمية أو المعلومات المضللة، ما يستدعي دورًا تربويًّا وإعلاميًّا جديدًا للدولة والمجتمع المدني، يضمن بيئة معرفية صحية لبناء وعي شبابي ناقد ومسؤول، مثال على ذلك: كما فعلت وزارة الاتصال الحكومي بإطلاق برنامج "إضاءات في التربية الإعلامية"، يقوم على توعية جميع فئات المجتمع، وكيف يتعامل المجتمع مع الأخبار المضللة، والإشاعات، وخطاب الكراهية، وكيف نتعامل مع الذكاء الاصطناعي، والتفرقة بين الأخبار الصحيحة والمغلوطة، والفرق بين التأطير والتنميط الإعلامي.
التوصيات:
يتضح من خلال تحليل الواقع الشبابي في الأردن أنَّ السياسات القائمة، رغم الجهود المبذولة، لم تتمكن من خلق بيئة حقيقية لتفعيل الطاقات الشبابية وتنمية المهارات بشكل منهجي. ويبرز التَّحدي الأساسي في غياب منظومة وطنية متكاملة تعالج المشكلات من جذورها، وتعيد هيكلة العلاقة بين الشباب والدولة كمكوّن أساسي في عملية التنمية.
فبناءً على ما سبق، تُقترح التوصيات التالية:
١- إعادة تصميم السياسات التعليمية؛ لتكون موجهة نحو اكتساب المهارات، مع التركيز على التعلُّم التطبيقي، وتوسيع نطاق التعليم المهني والتقني، وربطه بسوق العمل.
٢- إنشاء صندوق وطني؛ لتنمية المهارات وريادة الأعمال بتمويل مشترك بين الحكومة والقطاع الخاص، يوفِّر التدريب، والدعم المالي، والاستشارات لرواد الأعمال الشباب في مختلف المحافظات.
٣- مراجعة البيئة التشريعية؛ لتسهيل تأسيس المشاريع الناشئة، وتبسيط الإجراءات الإدارية، وتقديم حوافز ضريبية للشركات الريادية.
٤- إدماج الشباب في صنع القرار عبر تأسيس مجلس وطني للشباب يتمتع بصلاحيات استشارية ملزمة، وينتخب من ممثلين عن المحافظات والقطاعات الشبابية المختلفة.
٥- تفعيل دور المراكز الشبابية وتطوير بنيتها التحتية، وتحويلها إلى منصات حقيقية؛ لبناء القدرات، وليسَ مجرد مواقع للنشاطات الموسمية.
٦- إطلاق منصة وطنية رقمية موحدة تجمع البيانات المتعلقة بالشباب، والمهارات، والفرص التدرييية والوظيفية، بما يساهم في توجيه السياسات وتسهيل الوصول للمعلومات.
٧- تطوير برامج وطنية للإعلام الشبابي والثقافة الرقمية؛ لتعزز الوعي والانتماء، وتُشرك الشباب في صياغة خطابهم العام.
٨- دعم البحوث والدراسات المتخصصة حول الشباب، وربط نتائجها بصناعة القرار، بما يضمن استناد السياسات إلى معرفة علمية دقيقة وأيضًا محدثة.
ففي الختام:
إنَّ الشباب الأردني يُمثل الثروة الحقيقية التي يمكن أن تقود البلاد نحو نهضة اقتصادية واجتماعية حقيقية، إذا ما تم تفعيل طاقاتهم واستثمار مهاراتهم بالشكل الصحيح. فلقد بات من الضروري أن نُعيد التفكير في السياسات والبرامج الحالية التي تهدف إلى تمكين الشباب، وأن نركز على بناء منظومة شاملة متكاملة تربط بين التعليم، والتدريب، والعمل، والتمكين الاجتماعي، فالشباب ليسوا مجرد مستهلكين للفرص، بل هم شركاء أساسيون في خلقها وتحقيقها.
أنا شخصيًّا، كشاب أردني، أشعر بما يشعر به كل شاب في هذا الوطن، سواء كان ذكرًا أم أنثى. أعرف تمامًا التحديات التي نواجهها في محيطنا، وما يتطلبه الحال من تغيير جذري. لذا، فإنَّ هذهِ الورقة ليست مجرد دراسة أكاديمية، بل هي انعكاس لتجربة حية وواقع نعيشه جميعًا.
وربطًا بذلك، فإنَّ تحقيق هذهِ النقلة يتطلب مشاركة شاملة من جميع القطاعات، سواء كانت حكومية أو خاصة، من أجل خلق بيئة محفِّزة لريادة الأعمال، وتوفير الدعم المالي والتدريبي؛ لتمكين الشباب من تطوير أفكارهم ومشاريعهم. لا يجب أن تقتصر جهود الحكومة على توفير فرص العمل التقليدية، بل يجب عليها أن تخلق حوافز لتشجيع ريادة الأعمال، وتبني سياسات تعليمية مرنة تُركز على المهارات العملية التي تلبي احتياجات السوق المحلي والدولي.
إنَّ الشباب هم القلب النابض للتغيير، وهم القوة المحركة لتحقيق النمو والتطور. فالمضي قدمًا في ربطهم بالفرص التي تمكنهم من تحقيق إمكاناتهم هو الطريق الأمثل لبناء مستقبل أكثر إشراقًا. إذا أردنا تحقيق تنمية شاملة ومستدامة، يجب أن نضع الشباب في قلب استراتيجياتنا الاقتصادية والاجتماعية، وأن نمنحهم الأدوات والفرص التي تجعل منهم قادة الغد.